بقلم سليمان يوسف إِبراهيم- عنايا، لبنان
حبيب يونس ومارون أَبو شقرا شاعران، أمسكا بناصية الشِّعر بالمحكيَّة العاميّة كما بالفُصحى المشذّبة المصقولة، في زمن الحداثة. فالأوّل أنشأ دراسة تناول خلالها بالتّحليل حقبة خمسماية سنة على الشّعر اللّبناني. أما الثّاني فقد قدّم للقارئ طبقا من الأدب المقارن«بين الشِّعر اللُّبناني المحكي…والزّجل«. وما جمع بين العملَين أنّهما يصبان في مَعينٍ واحدٍ، مَعين النّقد والتّحليل، يقدمان »دراسة نقديّة تحليليّة« حول الموضوع، للعارف كي يتذكّر وللباحث كي يحظى بضالته من أقرب السّبل وأنفعها، من دون مماحكةٍ ولا مماطلةٍ، مبتعدَين عن الإطالة والحشو وحوشيّ العبارة، من غير طائلٍ.
في »الزّجل تاريخا وتطوّرا أوزانا وتميُّزا« يرى المؤلّف حبيب يونس أنّ وحدة الشّعر في الوزن الشِّعري »نابعة من عاملين: فطرية الإنسان التي كثيرا ما ساعدته على الإبتكار أو الإكتشاف، وتوقه الدّائم إلى الكمال، أي إلى تجنّب الخطأ، كما أنّ الطّبيعة المتوازنة والموزونة من حوله كاملة هي«. ويتابع المؤلّف الكلام حول تاريخيّة الإيقاع في الموسيقى الشّعريّة الّتي دفعته بالأساس للشّروع بكتابة مجمل دراسته، مجتازا بالباحث الرّوماني ماتيلا غيكا إلى الفرنسي ب.سيرفيان، وصولا إلى ماجاء عند جرجي زيدان عن أنّ وضع الوزن مأخوذٌ من توقيع سَير الجِمال في الصّحراء، وأنّه يعتقد أنّ بحور الشّعر عُرِفت من قَبل العرب وإلآ لما استطاع هؤلاء ضبط شعرهم… وما جاء أيضا على لسان البستاني »بأنّ معرفة الخليل بالأنغام نبّهته إلى وضع العروض لأنّ الموسيقى والشِّعر متقاربان في المأخذ. ويجدر بنا القول أن اكتشاف الحياة يكون من الحياة نفسها. فالإنسان، قليلةٌ هي الأشياء الّتي اخترعها بالنِّسبة إلى الأمور الّتي اكتشفها، وكانت موجودة في الأصل.فالفكر الإنساني يكتشف الحياة ولا يُبدعها. فالموضوع كله يقوم على تلاقُح الحضارات وتأثير بعضها ببعض: فاليونانيّة أَخذت عن السّاميّة، وكل الحضارات المتعاقبة بعدهما أخذت عن اليونانيّة… »فالزّجل قديمٌ قِدَم الشّعر عند العرب« ومارون عبود يدلي بدلوه في هذا المعرِض فيقول: »الزّجل سريانيّ اللّحن في أوّل عهده، وعربيُّه في ما بعد«. ونجِدُّ السّير في الدراسة لنصل إلى ميناء بحور الشّعر بين فصيحه والزّجل منه، لنخرج

بنتيجةٍ أنّ شعر الزّجل يتّبع في أصول وزنه »قاعدة واحدة هي عدد المقاطع، الّذي به تُعرَف أسماء أوزانها: الأسواني، المتساوي، المتوسِّط، المتقارب، المزدوج، المتناهي، السّريع، البسيط، الوفائي، المتوازي، الكامل، المتفاوت. ويمرُّ المؤلِّف في دراسته بالحديث على »برديصان« مبتدع الشِّعر السّرياني في القرن الثّاني والّذي عنه أخذ مار افرام السّرياني ألحانه معرّجا على رأي الفنَّان العراقي، الباحث يوسف عزيز الّذي يرى أن مار افرام أخذ الألحان ووقّع عليها أشعارا تتوافق والإيمان. وتتضمن الدّراسة كذلك فصلا في بحور الشّعر، مقارنة تشير إلى بحور العامي والزّجل من الشِّعر… فالمعنّى والقَصيد والميجانا كلّها على بحر الرّجز مثلا. فالمهمُّ المُلفت في هذا الجزء من الدِّراسة، التّأكيد على عمق البحث وتقصّي المعاني والمدلولات وملاحقة الفونمات لإكتشاف صحة نَسب الأنواع الشِّعريّة وربطها بالأوزان العائدة لها، ودقائق جوازات ألفاظها وطُرق إِسقاط وذكر حركات حروفها لإِبراز صحة الوزن ومطابقته للأنواع الشِّعرية الزّجليّة وبحورها الخاصّة. وفي الجزء الثّاني من الدّراسة، نجد المؤلّف حبيب يونس يُفرد فصلا يشير فيه ويدرس خلاله الأسباب الّتي آلت إلى تميّز الشّعر العامي والزّجلي وما دفع به على دروب التطوّر حيث ارتقى إلى المنابر والصُّروح، ولا زال حتّى يومنا هذا ينمو بشكل مضَّطرد، مجيبا خلال الدّراسة على أسئلةٍ، قطعَ خلالها درب الشكّ باليقين. امّا الجزء الثّالث من دراسته تحت عنوان: شهادات »المسايفة بالكلمة«؛ فأورد فيه شهاداتٍ في الزّجل، لكبار من الشّعراء نظرا لأهمية ما جاء فيها على لسانهم، أمثال: سعيد عقل، أسعد السِّبعلي، موريس عوّاد وزغلول الدّامور.
أمّا الشّاعر مارون أبو شقرا، وفي الفصل الثّاني من الدِّراسة، فيقوم بإنشاء مقارنةٍ بين الشّعر المَحكي من جهة والزّجل من جهةٍ أُخرى. فيعرِّف شعر الزّجل على أنّه »شعر العامّة«، أو هو »الشِّعر الشّعبي« أَمِ »الفولكلور« الّذي تشاركت في صياغته أذواق النّاس«. ليعود فيُبدي للقارئ جملة من خصائصه الّتي لا يختلف حولها اثنان، كالعفويّة، البساطة، السّهولة، المباشرة، الإرتجال، المحاجّة، التّباري، الغنائيّة الإطراب. ويفصّل الكلام حول أُخرى ممثِّلا عليها، كالفكاهة، كما ويركِّز على خاصّية الإطلالة في الزّجل، لأنه نوع شعريٌّ أطلّ على المجتمع الإنساني بالأساس، ليلوِّن مناسباته المتعدِّدة ما بين أفراح وأتراحٍ ونجاحات وتحقيق انتصارات، وكان من غائيته أيضا ملء الوقت بالماتع الشّيق الفريد لتعميم البهجة أم المؤساة، إلى أن بات الزّجل في عصرنا تخصّصَا من بين أنماط المِهن الفنيّة. وإجابة على سؤآل: ما هو الشّعر؟ يجيب مارون أبو شقرا، معرِّفا: »هو القول الّذي يقول ما يجب أن يُقال من دون أن يُقال«. ساردا بعض خصائصه متحدِّثَا عليها: النّحت بالصّعوبة، الحياكة العالية الجودة، العَمارة التّحفة، البناء الهندسي المُتقن المشغول، الإيحاء والإيماء، الغرابة المُدهِشة بفرادتها وفُجائيتها تجاوز المنطق فيها، هو نقيض الشّرح: »مهمَّة الشِّعر غير شارحة، للشِّعر مَهَّمة لامحة«.
في القسم الثّالث من الدّراسة يقارن المؤلّف بين خاصّة الإطالة في الزّجل الّتي يقابلها خاصيّة التّكوير، نحتا إيماء وإيحاء بتخيل المُراد في الشّعر العامّي. ثمّ في الرّابع يناقش خاصّة التّشابه في الشّكل والتَّباين في الجوهر بين النّوعين: »فالزّجل مصرٌّ على الوزن والقافية والقالب الجاهز، فيما يبتكر الشّعر قوالب تخدم رؤآه المتجاوزة بمرونة وحرّية«. وفي القسم الخامس يرى مارون أبو شقرا، إلى التعريفات المتداولة للشّعر أم للزَّجل على أنها تعريفات قاصرة عن إيفاء أي لون منهما حقه أو الإحاطة بتوصيفه توصيفا يحيط به إحاطة وافية. لذا، أراه يركز مفهومه للشِّعر بفرعيه، قائلا: »لا يمكن للّغة أن تحدِّد نوع الكتابة أو مذهب النّوع، مضمون النّص يحدِّد ذلك… فإمّا أن يكون المضمون شعرا، أو يكون زجلا، أو أن يكون هراء«. وحينها، برأيي، يخرج من الناديين!!! أمّا الحديث عن »لغة الشّعر« في القسم السّادس من الدِّراسة، يرى المؤلّف أنّه »ليس هناك من لغة جميلة وأُخرى غير جميلة؛ بل هناك نص جميل وآخر غير جميل. فاللُّغة في حال اللآتعبير واللآّجمال، لا قيمة لها«. وفي السّابع منها، يُنشيء المؤلف مقاربة يُظهرُ فيها أن الشِّعر نوعٌ من الصِّناعة العالية، حيث أنّ »اللّغة مقلعٌ غنيٌّ والشّاعر بنَّاءٌ ماهر…« وفي مقارنته يجد كذلك انَّ » الشِّعر يبحث عن رؤيا وكشفٍ وجزرٍ بكرٍ، في حين أنه في الزَّجل بحثٌ عن وقتٍ أطول وقافيةٍ ووزنٍ… الشِّعر غير مُجبرٍ على الإضافة، على العكس هو يبحث عن الإختصار والتّقليل وتكوير المعنى لتجميل الصّورة…« ويتابع خاتما: »يكتفي الزّجل ببعض صناعةٍ شكليّةٍ، فيما يوغل الشِّعر في النّحت والحفر والإختزال والإختصار والتّصوير والتّلوين«. كما ونجد المؤلّف يقيم دراسة خصائصيّة بين الزّجل والشعر في قسمها التّاسع تؤكّد جماهرية الأوّل وفنيّة الثّاني مستخلصا أنّ«الزّجل فنٌّ تُراثيٌّ، يستعيده محبّوه… بينما
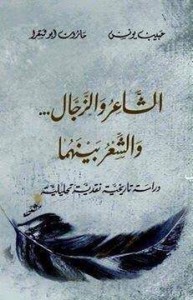
الشّعر تجاوزٌ وفعلٌ اختراقيٌّ وتكوينٌ جديدٌ وحداثةٌ في التّركيب والتّصوير ونحتٌ في الجمال«. وفي ختام المِبحَث، يبيّن مارون أبو شقرا، في الفصل التّاسع والأخير كذلك، أثر المدرسة الحديثة في »الشّعر اللّبناني المحكي«، ليخلُصَ إلى نتيجةٍ مُفادها: » إِذا كانت الكلاسيكيّة في القصيدة العربيّة، في رأيي، هي »الطّرح«، والحداثة هي »نقيض الطّرح«، فإنّ جدلهما أدّى إلى »خلاصة« برزت في القصيدة العاميّة، عملا بدياليكتيك هيغل«.
إِستنبطتُ من عنوان كتابكما بعض توريةٍ: فالزَّجل زجلٌ والشِّعر شِعرٌ، أما في ما بينهما فالتّوريةُ تكمنُ. أَهي جمعٌ لِما تشاركا به من خصائص معنوية وأُسلوبيّة، أَمْ هي دعوةٌ مغلّفة بظُرف الطّلب، لإسقاط ما سُمّي بالهراء في النَّسوة العَجلى برفقة ناظميه من فهرستهما؟ لستُ أعلم، إن كنتُ قد أصبتُ بشيءٍ ممّا تهيّأ لي، أو أنّني حمَّلتُ قلمي وِزرَ ظنّي بما قصدتما إِليه؟!!
مهما يكن من أمر، تبقى أهمّيّة هذا الكتاب الدّراسة، بجدّيّة ما قدّمته للقارئ العربي، وما أضافته على المكتبة العربيّة من معارفَ حمّلها إيّاه المؤلِّفان حبيب يونس ومارون أبو شقرا، من مخزونٍ ثقافيٍّ ومعلوماتيٍّ ثَرّ، حول الموضوع الذي تناولاه -على حداثته- كلٌّ من منظوره حيث شكّلا وحدة عضوية موضوعيّة رائدة في إصدار فكرهما في كتاب واحد، تُغني الفكر ويُطرَب لها القلب؛ فتدفع بقرّائهما إلى مطالبتهما بالسّعي نحو المزيد تحقيقا لآستزادةٍ وتعميما لفائدة.
سليمان يوسف إبراهيم

